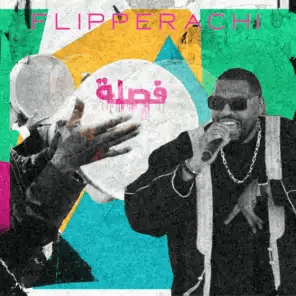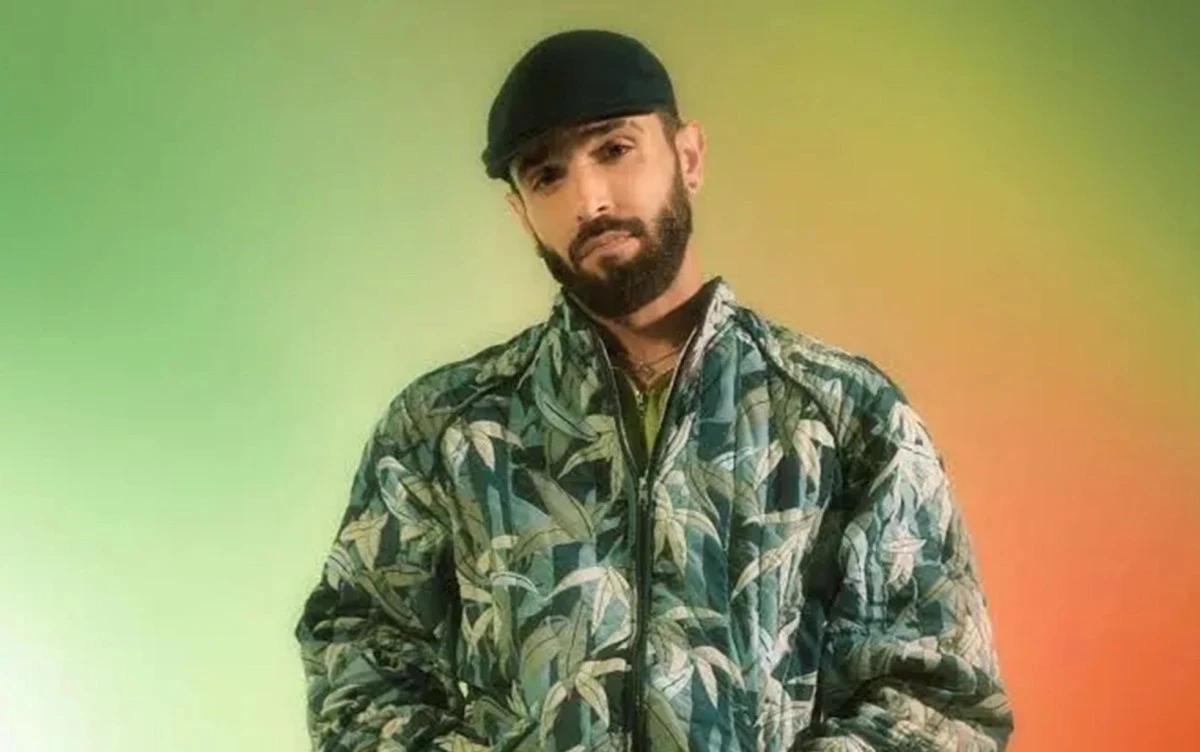عاشت الموسيقى النوبية على طول نهر النيل من شمال السودان إلى جنوب مصر، حافظ فيها شعب النوبة على إرثهم وتراثهم ولغتهم مع السنين، رافقت كل تفاصيل حياتهم من الفرح والأعراس إلى الهجرة والغربة، ولو كانت حياة النوبيين فيلمًا لكان كل مشهد مرفق مع ساوندتراك من هذه الموسيقى.
اعتمدت الموسيقى النوبية على الإيقاع الخماسي الإفريقي وهو ما ميّزها عن باقي أشكال الموسيقى في مصر، كما أثرت بصورة واضحة على الفنون السودانية التي اندمجت مع خصائصها. في بداية تشكلها، كانت الآلات الإيقاعية مثل الدف والذي يسمى الطار باللغة النوبية إلى جانب الطنبورة هي الأساسية، ويقال أن الطار فيه أربعة أصوات: الماء والهواء والنار والتراب، حيث استطاع العازفون النوبيون أن يخرجوا بإيقاعات في غاية التطريب.
كانت تسمى الجلسة أراجيد وتعني الأفراح، حيث يتوسط المغني عازفي الإيقاع بينما يقف حوله الرجال والنساء وهم يرقصون بحركة تحاكي أمواج النيل. كل طقس من طقوس الحياة في النوبة كان مصحوبًا بالغناء من الولادة إلى الحصاد والزرع وأشجار البلح، أما الأعراس فهي الاحتفالات الكبرى من ليلة الحنّاء إلى الاحتفال بالعرسان.
موقع النوبة الجغرافي على ضفاف النيل أثَّر على صناعة الموسيقى بشكل عام، خاصةً الهجرات المتتالية التي فرضت على الشعب عند بداية القرن العشرين، بسبب بناء خزّان أسوان لتخزين مياه النيل وبعدها بحيرة ناصر والسد العالي في الستينيات، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه وغرق القرى النوبية وتهجير أهلها مع الاحتفاظ بما يسمى بحق العودة.
هاجر الفنان حمزة علاء الدين من قريته توشكى محمّلًا بالتراث النوبي، وكان أول من أدخل آلة العود على الموسيقى النوبية، وعمل على تجميع الشعر والأغاني من القرى التي اعتمدت على التوارث الشفهي خاصة وأن اللغة النوبية في خطر الاندثار. كما أنه تعاون مع الفنان محيي شريف الدين وغيّروا شكل الأغنية النوبية بإضافة كوبليه ومذهب، وصنعوا أغاني جديدة بمواضيع تمسهم مثل التهجير وحق العودة. جاب حمزة بعدها العالم من اليابان إلى أميركا ونقل قصة النوبة بصوته شديد العذوبة، وقدم أسطوانات مهمة مثل "ساوند أوف ذا نايل".
عرفت فترة الستينيات هجرة كبيرة لأهل النوبة إلى القاهرة، وهناك بدأت الموسيقى النوبية تنتشر بعد أن كانت غير مسموعة. ساهم الموسيقييون مثل علي كوبان مع فرقته في تسخير المزيد من الآلات مثل الساكسوفون والكلارينيت في خدمة السلم الخماسي. كما تعاون مع فنانين مهمين مثل حسين بشير، وأصدر كاسيت "سكر" مع شركة الدلتا وفتح الطريق أمام باقي الفنانين لإصدار الشرائط مثل بحر أبو جريشة وشمس حسين مع فرقة النيل النوبية وحسين بشير وغيرهم من الفنانين.
لعب أحمد منيب دورًا هامًا في إيصال صوت هذه الموسيقى إلى المنطقة، فأطلق ألبوم "مشتاقين" في الثمانينيات والذي حمل أسلوبًا غنائيًا بسيطًا، وطغت عليه المواضيع الفلسفية مثل حب الحياة وحمل العودة والشوق الدائم لضفاف النيل والجذور "مشتاقين يا ناس لبلاد الدهب". دعم منيب الجيل الجديد من الفنانين وأخذ الشعر النوبي من الشعراء الصاعدين مثل ياسر أبو النصر في الأغنية الأيقونية "في دايرة الرحلة"، كما تعاون في هذا الألبوم مع حميد الشاعري بالتوزيع الذي رسخ صوت الإيقاع الخماسي.
عندما ظهر محمد منير للمرّة الأولى بدا وكأن الجميع كان بانتظاره، حتى أن أحمد منيب وجد في صوته أرضًا خصبة للتجريب والتطوير بالأغنية النوبية، واستثمر معه كل الموسيقيين الرواد في الساحة من هاني شنودة إلى يحيى خليل، بالإضافة إلى الشاعر عبد الرحمن منصور. وهكذا ولدت ألبومات رسخت الصوت الصوت النوبي مثل "بنتولد" و"علموني عنيكي"، حتى جاء ألبوم "شبابيك" والذي شكل ثورة في عالم الموسيقى النوبية والمصرية.
وصل صوت منير في هذه الألبومات إلى كل شارع وحارة في مصر ومنها إلى السودان وباقي العالم، أدخل على الموسيقى آلات مثل البايس والدرامز وتأثيرات من الجاز مع يحيى خليل، ما جعل لكل مقطوعة أسلوب مختلف. كتب عبد الرحمن منصور مواضيع غير اعتيادية بعد ما كانت الأغنية الرومانسية للحبيب هي السائدة آنذاك، غنّى منير للحياة وشجر الليمون والمدينة وفلسفة الوجود.
حاول بعض الفنانين التجريب بصوت الموسيقى النوبية مثل محمد فؤاد في ألبوم "حبينا" بأغنية "الليل الهادي". كما دمجت بعض الفرق لاحقًا التأثيرات النوبية مع الهيب هوب وغيرها من الأنواع مثل فرقة بلاك تيما، وتأسست مع الوقت مشاريع جديدة مثل مشروع النيل مع السارة والنوبة تونز، والتي استعادت أغاني من تراث النوبة مثل "نوبة نوتو" باللهجة النوبية الأصلية.
لم تكن الموسيقى النوبية موسيقى تراثية وحسب، بل كانت تعبيرًا سياسيًا واجتماعيًا عن القرى المهمشة والبعيدة عن مركزية المدن الكبرى، كانت صوت المهاجرين الذين لم يتخلوا عن جذورهم يومًا. رسخت هذه الأغاني بإيقاعها الخماسي صوت الطبيعة وخصوبة النيل، وتطورت مع الوقت والزمن لتحافظ على إرث فني بقي حيًّا رغم التهجير والغربة.