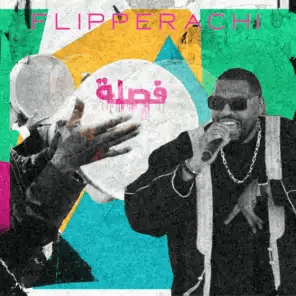لم تكن حكاية لقاء فيروز مع محمد عبد الوهاب مجرّد تلاقٍ بين مطربة لبنانية وموسيقار عربي كبير، بل كانت أشبه بلحظة عبور موسيقي بين مدرستين، تكادان تتناقضان بقدر ما تتكاملان: مدرسة أغاني الضيعة الجبلية التي بناها الرحابنة بالحجارة والريح وأجراس الصباح، والمدرسة الموسيقية المصرية الطربية، التي كان محمد عبد الوهاب من أبرز أعلامها. وحين وُضع صوت فيروز بينهما، كان أشبه بنهرٍ رقيق، يعبر أرضين ويجمعهما في مجراه.
حدث ذلك في مناخ عربي نابض بالتحوّل. كانت أواخر الخمسينات وبدايات الستينات زمنًا يتنفّس فيه العالم العربي حلمًا واسعًا، تتردّد في هوائه أصداء الوحدة بين مصر وسوريا، وتعلو فيه رغبة شعبية وثقافية برسم خطوط للتلاقي. وفي هذا المناخ الذي بدت فيه المنطقة كلّها تتحرك نحو أفق جديد، بدأ التجاذب بين تلك العوالم الموسيقية المختلفة، لتغنّي فيروز من ألحان محمد عبد الوهاب، في تجربة استثنائية في تاريخ الموسيقى العربية، تكسّرت فيها الحدود، ليلحّن عبد الوهاب أغنية باللهجة اللبنانية للمرة الأولى، وتبدأ الرحلة مع "سهار".
البدايات: إشارات تأتي من بعيد
كان عبد الوهاب، بطبعه المتأمّل، يُصغي لصوت فيروز كما لو أنه يلتقي شيئًا لم يعهده. ذلك النقاء الذي تتردد فيه نبرة صلاة. أدرك مبكرًا أن هذا صوتها ليس مجرّد ظاهرة، بل علامة على ميلاد مشهد جديد في الغناء العربي، مشهد يستند إلى البساطة العميقة وإلى الصورة الشعرية الخفيفة والرقيقة لا إلى الطرب والزخارف اللغوية.
من جهتها، كانت فيروز تقف على الضفة الأخرى مستعدةً للعبور. وكانت مصر، بتاريخها وجمهورها وإعلامها، بوابة كبرى لا يمكن لأي فنان عربي أن يتجاهل وهجها. وجاء عبد الوهاب ليفتح لها هذا الباب. ولكن تجربة فيروز المصرية كانت مختلفة عن تجربة أي فنان عربي آخر، فلم تنصهر في بوتقة مركزيتها، ولم تكتفِ بتجربة الأغاني المصرية الطربية، بل جاءت بلمستها الخاصة التي كسرت معها المركزية.
سهار بعد سهار:
وبعد تصريحات الإعجاب المتبادلة، جاءت "سهار" عام 1961، كأول تعاون بين فيروز وعبد الوهاب. كانت الأغنية أشبه بخطوة أولى يتحسّس فيها كل طرف طريقه نحو الآخر. حمل الرحابنة النص إلى عبد الوهاب، وكان نصًا بسيطًا من تلك النصوص التي يجيدون صياغتها: لغة قريبة من الناس وجو ليلي هادئ وإحساس متدرّج بين الانتظار والحنين.
قرأ محمد عبد الوهاب الكلمات بعينٍ فاحصة، وتوقّف عند بعض التفاصيل الصغيرة التي لفتته، ومنها جمال حرف التاء باللهجة اللبنانية، الذي يختصر كلمة "علشان" بالمصرية، والذي تم استخدامه بمطلع الأغنية في جملة "ت يحرز المشوار"، وقال في إحدى حواراته إنه أعجب بـ"رشاقة العامية اللبنانية في اختزالها التعبير بهذا الشكل الجميل".
وعندما بدأ العمل على اللحن، بدا واضحًا أنه لا يريد أن يجرّ الأغنية إلى عالمه الطربي المصري تمامًا، بل أن يجد منطقة وسطى تحافظ على طابع الرحابنة وفي الوقت نفسه تحمل بصمته الخاصة. فجاء اللحن هادئًا، قريبًا من طبيعة الكلام، ويترك لفيروز مساحة واسعة لتظهر نبرة صوتها الناعمة. في التسجيل الأول، كانت فيروز تتقدم الجملة الأساسية، ويأتي الكورال من خلفها ليعطي الأغنية طبقة إضافية من الدفء. ويُحكى أن عبد الوهاب وقف مع الكورال، كأنه يريد أن يعيش التجربة من داخلها لا من خلف الزجاج.
سكن الليل:
مع "سكن الليل"، بدا التعاون بين فيروز ومحمد عبد الوهاب وكأنه يتقدّم نحو منطقة أكثر رهافة. فهنا تم العودة إلى قصيدة لجبران خليل جبران، من شعر المهجر اللبناني، وتحمل القصيدة تلك النبرة التأملية التي تميّز أدب جبران: لغة بسيطة ولكنها مشبعة بشجنٍ داخلي، وروح تمشي بين العتمة والضوء كما لو أنها تبحث عن مكان تستقر فيه.
وجد عبد الوهاب نفسه أمام شعر باللغة العربية الفصحى ولكن من نوع خاص، لا ينغمس بالخطابة ولا يحتمل الزخارف الثقيلة. لذلك اختار أن يضع اللحن كما يضع المرء يده على صفحة ماء: ليكتفي بحركات صغيرة كانت كافية لتحريك السطح بكامله. استمع إلى الإيقاع الخاص بكلمات القصيدة، وتركها تقوده نحو حالة من التأمل الموسيقي، فيها شيء من السكون والروحانية الصوفية، تمامًا كصوت فيروز. وكان اللحن في تلك المساحة، لا يرتفع إلا بقدر ما يحتاجه المعنى، ولا ينخفض إلا ليحمي الهشاشة التي تركها جبران بين السطور.
مرّ بي يا واعدًا وعدًا
مع "مرّ بي"، بدا التعاون بين فيروز ومحمد عبد الوهاب وكأنه يصل إلى مرحلة ناضجة من التفاهم الفني، فقصيدة سعيد عقل تحمل تلك الرقة المختلطة بشيء من الكبرياء، ولغة عربية مشغولة بعناية تجعل كل كلمة مصقولة ولها وقعها. كانت القصيدة تحتاج إلى ملحن يستطيع أن يحافظ على وضوحها دون أن يغطيها، وإلى صوت قادر على إبراز ما فيها من إحساس دقيق دون مبالغة.
اختار عبد الوهاب للقصيدة لحنًا هادئ، يتصاعد تدريجيًا، ويمنح الكلمات وقتها لتستقر في الأذن. لم يعتمد على الجمل الطويلة أو التلوينات الثقيلة، بل على حركة موسيقية بسيطة ومدروسة، تحافظ على الجو الحالم الذي ينساب من القصيدة نفسها. بدا اللحن وكأنه يرافق الكلمات بدل أن يقودها، ويعطي لفيروز مساحة واسعة كي تُشكّل الأداء بطريقتها. وقدمت فيروز الأغنية بطبقة صوتها الأثيرية، لتمنح الأغنية سحرًا خاصًا وتمنح اللحن طبقة من الصفاء لا يمكن فصلها عنه. ورغم أن التعاون لم يستمر بعد ذلك طويلًا، فإن هذه الأغنية بدت وكأنها الخاتمة الطبيعية لمسار قصير لكنه مؤثر.
من أرشيف عبد الوهاب: "خايف أقول" و"يا جارة الوادي"
"يا جارة الوادي" و"خايف أقول اللي في قلبي" – عودة إلى عبد الوهاب من باب جديد
وإلى جانب الأغاني التي لحّنها عبد الوهاب خصيصًا لفيروز، قدمت أيضًا اثنتان من روائعه بصوتها. الأغنية الأولى هي بالأصل قصيدة لأحمد شوقي، "يا جارة الوادي"، لحّنها عبد الوهاب عام 1928، وأعادت تقديمها فيروز معه بعد أن التقيا عام 1961، وفيها حافظت فيروز على الطابع الطربي، لتكون الأغنية الأكثر ثقلًا والتحدي الأكبر بالتجربة الفيروزية الوهابية.
أما الأغنية الثانية، "خايف أقول اللي في قلبي"، فكانت تجربة أكثر إثارة، فهي الأغنية الوحيدة التي غنتها فيروز باللهجة المصرية من ألحان محمد عبد الوهاب، وتمكنت فيها من إضفاء طابع خاص على الأغنية التي قدمها عبد الوهاب أول مرة سنة 1929؛ فاللحن الذي عرف عبد الوهاب كيف يصوغه برهافة الاعتراف بالحب، بدا ملائمًا لرقة صوت فيروز، وكأنه قد صنع بالأصل لها.
ما لم يكتمل: ظلال الحكايات التي بقيت عند الباب
وكما هي عادة اللقاءات الكبرى، لم يكتمل كل شيء كما يُراد له. كانت هناك أغنيات تنتظر أن تُولد، لكنها بقيت على أطراف الحلم. من بينها "ضيّ القناديل"، التي لحّنها عبد الوهاب لتغنيها فيروز، لكنها رفضتها فانتقل اللحن إلى عبد الحليم حافظ، بعد إعادة صياغة النص باللهجة المصرية.
ولم تكتمل بعض المشاريع الأخرى، ربما لضيق الوقت، وربما لأن الحكاية نفسها أرادت أن تبقى قصيرة، كأنها تعلم أن ما اكتمل منها يكفي ليظلّ خالدًا.